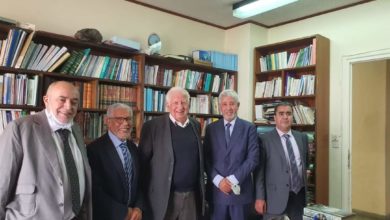الزوايا والأضرحة.. البحث عن الخلاص المزيف
◆ جهاد الگنوني

لا شك أن العلوم الإنسانية، بما فيها العلوم النفسية والاجتماعية إلى جانب الفلسفة، ساهمت بقسط كبير في تعميق فهم الناس لذواتهم ومحيطهم وأشكال علاقتهم وكيفية عمل مؤسسات تنشئتهم، فالفلسفة على سبيل المثال لا الحصر، كبحث مستمر وتساؤل دائم للبديهيات التقليدية والثابتة وتحريض العقل على التفكير والتدبر وتدريبه على النقد والتجريد وعدم تقبل الجاهز من الأفكار والإيديولوجيات و الممارسات، فتحت المجال للعقل البشري للاكتشاف الواسع للمعرفة اليقينية والعقلية، بدءا من ذات الإنسان مرورا بمحيطه الاجتماعي إلى العالم المشترك، بفك ألغاز الطبيعة وتفسير قوانينها.
لقد جاءت الفلسفة لتؤطر وتوجه عملية التفكير ومهارتي التمحيص والفحص، وذلك من خلال كيفية طرح السؤال والقدرة على تجاوز طرح السؤال البسيط نفسه، والذي قد يعد قدرة من القدرات الفطرية المصاحبة للوعي الإنساني منذ الأزل قبل اكتشافه النار والصيد.. فالطفل في مراحله العمرية الأولى يستطيع أيضا طرح السؤال الوجودي المباشر بشكل عفوي وتلقائي خال من أي قاعدة أو قانون، مدفوعا بالرغبة في المعرفة والبحث عن جواب يقيني من قبيل ” كيف وجدت وحضر كياني لهذا العالم” و قد يحصل على إجابة شافية وقد يرافقه فراغ الإجابة إلى مثواه الأخير.
من مهام التفكير الفلسفي العقلاني أيضا هو تكسير حاجز الصمت داخلنا وتحطيم بعض التمثلات الاجتماعية، وتبيان عيوبها وجوانب قصورها. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟، وماذا لو لم تنجح العلوم الإنسانية التي اكتشفت حديثا في قهر سلطة الغول المتوحش داخلنا، ألا و هو الخوف من فراغ الإجابة أو عبثيتها، الخوف من المجهول والمستقبل، ومن العقاب واللعنة؟؟
لقد عمل الإنسان منذ الأزل على مقاومة الشعور بالخوف لديه، هذا الشعور الغريزي الذي يتقاسم مرارته مع الحيوان أيضا، بشتى الطرق وبمختلف الوسائل التي صنعها وابتكرها، لكنه عدو شرس له من القوة ما يمكنها أن تدمر الإنسان وتبتلعه ليتحول هذا العراك إلى صراع دائم مخلفا وراءه الكثير من المعاناة والألم. لذلك، وفي لحظة من لحظات تطور الفكر والكائن البشريين، لم يجد الإنسان له منفذا سوى في التعبيرات الفنية وداخل حبكة الأساطير والقصص الخيالية الخرافية وبين التفسيرات الدينية والأطروحات الفلسفية،
ومن بين أشكال التنفيس الجماعي والفردي عن الألم والخوف يمكن الحديث هنا عن “ظاهرة الزوايا”.
إن استحضار نظرة عامة على جغرافيا المغرب يعطينا صورة واضحة عن الانتشار البين ل “مؤسسات” الأضرحة والزوايا المنتشرة في مختلف المناطق، دون تمييز بين الحواضر والبوادي، والتي تمتد من حيث زمن تأسيسها من عهد الأدارسة إلى وقتنا الراهن.
إن الزوايا والأضرحة تعتبر مرتعا تلتجئ إليه الأرواح المتعبة من قساوة الحياة، باحثة عن خلاصها واستقرارها النفسي والذهني ضمن وجع الجماعة المشترك، كيف لا ونحن أصحاب المثل العربي “إذا عمّت هانت”، فكلما كانت المصائب والمأساة جماعية كلما قل ثقل حملها. وفي هذا الصدد نستحضر قولة للكاتب المصري يوسف زيدان في روايته “عزازيل” التي سرد من خلالها قصة الراهب هيبا، ذاك الشاب الذي جال أرض الله الواسعة من أجل البحث عن الحرية وتحقيق العدل، هذه الحرية التي سلخت وعذبت في سبيلها الفيلسوفة والعالمة هيباتيا أيضا، والتي ذكرت كوجع لا كبطلة ضمن الرواية نفسها.
تقول المقولة “لا يوجد في العالم أسمى من دفع الآلام عن إنسان لا يستطيع التعبير عن ألمه”. ولعل زيارة الأضرحة والمشاركة في طقوس الشعوذة والتقديس، ماهي إلا إفصاح غير مباشر عن خيبة الأمل والخذلان اللذان قد يصطدم بهما الإنسان حينما يشقى ويخفق في طرح السؤال والتعبير من مشاعره وإحباطاته، والتي لا تجد مكانا يأويها ويحتضنها، وأحيانا يلتجئ الإنسان لأي مكان حتى لو كان وهما من أجل الاستمرار والعيش.. وتلك وظيفة الزوايا في مجتمع لم تتوفر له بعد المقومات العقلانية الحقيقية لبناء وضمان وجوده.