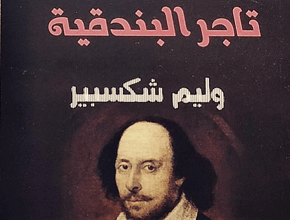العنف والدولة: وسيلة أم غاية؟
خالد البكاري

كلما تصاعدت ممارسة الدولة المغربية للعنف غير المتناسب في فض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، إلا وطلع علينا التبريريون باستدعاء مفهوم: العنف المشروع لماكس فيبر، استدعاء خارج قيوده المرجعية والنظرية، استدعاء حول العنف المشروع من مفهوم إلى عبارة مسكوكة.
لقد انطلق ماكس فيبر من تصور براغماتي/ واقعي للدولة، يعتبر ممارسة السياسة في إطارها محكومة بالمصلحة (الفردية والجماعية)، وبالتالي فاحتكار الدولة للعنف، هو بغية تنظيم المجتمع وتوجيهه، في مواجهة التصورات المثالية التي كانت تعتبر أن تحقيق العدل والحق في المجتمع كفيلان باستبعاد حاجة الدولة للعنف من أجل التنظيم والضبط.
هذا التجاذب بين الحق باعتباره غاية، وبين العنف المشروع باعتباره وسيلة إلى جانب وسائل أخرى لتنظيم المجتمع، يتأثر بالعلاقة بين الدولة وأجهزتها (التنفيذية والتشريعية والقضائية) باعتبارها أدوات لتنظيم المجتمع من جهة، وبين الأفراد الذين هم خاضعون لهذه الأجهزة من جهة أخرى، فإذا كانت هذه العلاقة يؤطرها مبدأ «التعاقد الاجتماعي « الذي يفيد تخلي الأفراد طوعا عن جزء من حريتهم للدولة من أجل تنظيم المصالح المتضاربة للأفراد، وهو تنازل تضبطه مدونات قانونية تحوز رضا أغلبية المجتمع، وتحترم حقوق أقلياته، فآنذاك يكون عنف الدولة مشروعا باعتبار هذه المرجعية التعاقدية، أما حين تكون علاقة الأفراد بالدولة مبنية على الإكراه، إكراه بمرجعية دينية (نظرية الحق الإلهي، الآداب السلطانية، ولاية الفقيه…) أو نتيجة استبداد الأغلبية (الدينية أو العشائرية أو الإثنية..)، أو بسبب تغول جهاز يمتلك أدوات القمع والضبط (الدولة العسكرية ونظيرتها البوليسية)، أو غيرها من ضروب التسلط والإكراه، فإن مشروعية عنف الدولة تنتفي، ويصبح هذا العنف ليس وسيلة تنظيم للمجتمع غايته: المصلحة العامة، بل أداة للقهر والتعسف لصالح فرد (الحكم الفردي الديكتاتوري) أو طبقة (أسرة حاكمة، عسكر، أوليغارشيا ،،،).
وإذا كان ماكس فيبر يعرف الدولة انطلاقا من العنف، مشروعا كان أو غير مشروع، فلا وجود تأسيسيا للدولة عنده خارج قدرتها على احتكار العنف، والفرق بين الدولة الديموقراطية وغير الديموقراطية هو فقط في شرعية هذا الاحتكار المخول لها انطلاقا من التعاقد وهي حال الدولة الديموقراطية، وفي لاشرعيته حين تكون الدولة مفتقدة للشرعية، ومشروعية العنف آنذاك نابعة من التسلط (في الفقه السلطاني يسمى هذا: شرعية المتغلب بالسيف).
ثمة مفكرون بعده من أعادوا النظر في هذه «المسلمة»، التي تعني قيام الدولة على العنف وجودا وعدما، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نورد تصور بول ريكور، الذي يعتبر أن المحدد في وجود الدولة هو شرعية «السلطة» وليس شرعية «العنف»، إذ الدولة القائمة على التعاقد تحوز شرعيتها انطلاقا من القانون/ القوانين، وبالتالي فدولة الحق تعرف بالقانون الذي يحوز رضا الأفراد والمجتمع، أما العنف فلا يمكن اعتباره محددا للدولة العصرية، إذ لا يمكن تخليصه من العلة التأسيسية له، والتي هي: الإكراه،، وتبعا لذلك فالدولة تنظم المجتمع انطلاقا من السلطة المخولة لها بالقانون، وليس انطلاقا من أي عنف مشروعا أو غير مشروع،، وحين تلجأ الدولة للإكراه فيكون الأمر على سبيل الاضطرار لإنفاذ السلطة التي لا تعني شيئا غير القانون.
في الأدبيات الماركسية نجد تضخما في الحديث عن العنف الثوري كآلية للمرور نحو الدولة الاشتراكية، أكثر مما نجد حديثا عن العنف المشروع للدولة، فقد انشغل الماركسيون بسؤال فهم وتفكيك الرأسمالية في أفق القضاء عليها، وكان النقاش بينهم حول: هل العنف إجراء ضروري لإحداث القطيعة مع نمط الإنتاج الرأسمالي كما هو حال اللينينيين، الذين يعتبرون العنف الثوري وديكتاتورية البروليتاريا غايتين ووسيلتين في الآن نفسه، أم هو فقط إجراء مؤقت اضطراري وقد يتم استبعاده إذا كانت سياقات تطور الديموقراطية البورجوازية تسمح بانتقالات سلمية، وهذا حال الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يحصرون الاشتراكية في برامج اجتماعية واقتصادية يمكن تحقيقها تدريجيا عبر مراكمة المكتسبات لصالح الطبقة العاملة (الأجور، أنظمة الحماية الاجتماعية…).
لكن اللافت أن ماركس نفسه لم يعتبر العنف محددا للدولة ولوجودها ولشرعيتها، فهو يعتبر أن عنف الدولة حتى المشروع منه (في نظام ديموقراطي بورجوازي ) ما هو سوى جبل الجليد الذي يخفي التناقضات الطبقية، ففي «الإيديولوجية الألمانية» يعتبر معية إنجلز أن دور العنف في نشوء الدول والملكيات الخاصة هو دور هامشي أو عرضي، وليس دورا رئيسيا، وإن كانا يقران بأن ظهور مجتمع جديد عادة ما يقرن بالعنف، لكن هذا العنف ليس هو العلة التأسيسية، فأمره شبيه بآلام الطلق عند الولادة، فتلك الآلام لا تعدو أن تكون من أعراض الولادة، وليست هي المتحكمة في خروج الجنين للحياة، فإذا كان العنف ملازما للصراع حول الملكية الخاصة، فإن هذه الأخيرة مشروط وجودها بالعمل، الذي ينتج هذه الملكية الخاصة، وبالتالي فالعمل هو سابق للعنف باعتباره هو الخالق للثروة وللملكية الخاصة ولوسائل الإنتاج. ورفض ماركس تصورات الداروينيين الاجتماعيين الذين سحبوا العنف الغريزي الموجود في الطبيعة على المجتمعات البشرية، واعتبره نقلا متعسفا، وبالتالي قدم نقدا حتى لبعض منظري نظرية العقد الاجتماعي مثل هوبز، الذي كان يعتبر تدخل الدولة ضروريا للجم النزوعات الغرائزية المتأصلة عند الكائن البشري،، إذ الانتقال من الطبيعة نحو الثقافة لا يعني عند هذا الأخير تخلصا من الغرائزية بل تنظيما لها. ويعتبر ماركس أن هذه النظرة لا تخلو من قدرية، بل هي نوع من التضليل الإيديولوجي الذي هدفه إخفاء علاقات الهيمنة والاستغلال، ومحاولة للجم إمكانيات القضاء على العنف ولجمه.
حين نعود إلى تراثنا الذين لا زال يحكمنا سلبا أو إيجابا، رغم كل محاولات التحديث سواء بالتثقيف أو بالقسر، لا نجد موقفا سلبيا من عنف الدولة، ذلك أن القيمة الأساس لمشروعية الدولة/ الحكم/ الحاكم،، هي قيمة الحق بمعناه الديني،، ولا وجود إلا فيما ندر لقيمة العدل، وهو وجود لاحق للحق، فلا عدل إلا بمقتضى ما تقوله الشريعة، وليس بمقتضى عقد اجتماعي، وبالتالي فعنف الدولة هو عنف شرعي ديني، ولم تختلف هذه الدولة السلطانية عن دولة الحكم الإلهي سوى في تقييدها بنصوص القرآن والأحاديث النبوية واجتهادات الفقهاء وفق قواعد تأصيلية، فيما كانت علاقة الحاكم وفق نظرية الحق الإلهي بالسماء مباشرة ومطلقة وغير مؤطرة بنصوص… وبرغم التطورات التي حصلت في مجتمعاتنا بعد المرحلة الكولونيالية، فما زالت الأحكام السلطانية لم تتراجع سطوتها، برغم كل مساحات التحديث (القانوني والدستوري والإداري…)،، لذا يتراجع النص القانوني أمام سطوة الحاكم، ويتضخم دور الملك/الرئيس الفرد حتى على حساب مؤسسة الملكية /مؤسسة الرئاسة/الحكومة ، وهذه الفردنة للحكم تشتغل حتى في باقي الأجهزة والمؤسسات والقنوات: الوزير، المسؤول الأمني، الوالي، مما يجعل الحديث عن عنف الدولة المشروع نوعا من الترف، إذ ما زلنا في مجتمع دولة الحكم الفردي، ولم ننتقل بعد لدولة المجتمع التعاقدي رغم كل التراكم في النصوص والتجارب والصراعات.